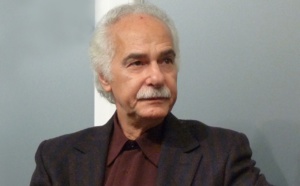العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
استفاقت دول القارة العجوز من الصدمة العنيفة التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية الطارئة المتمثلة في جائحة كورونا، على حقائق كثيرة مستخلصة من دروس السنتين العجاف التين عاشتهما الإنسانية، بسبب فيروس غير مرئي لا يزال جاثما على انشغالات المجتمع الدولي برمته، منبها إلى إمكانية عودته من جديد من خلال تواصل توالد سلالات كثيرة ومتعددة عجز العقل البشري عن فهم أسباب كل هذه القوة التي يتملكها الفيروس .
ومن المؤكد فإن الحقيقة الديموغرافية كانت من أهم الحقائق التي دفعت بها الأزمة الصحية العالمية إلى واجهة الاهتمام، حيث عجزت كبريات الدول التي تتغنى بقوة وصلابة بنيتها الصحية على الاستجابة إلى الحاجيات الملحة التي توقفت عليها حياة شريحة هامة من السكان، والمتمثلة في المواطنين المسنين.إذ من المعلوم أن فيروس كورونا وجد تربته الصالحة في الأشخاص الذين يعانون من هشاشة اجتماعية أو ضعف في المناعة، أو هما معا، وهذه أهم العوامل التي مكنت الفيروس من الانتشار كالنار في الهشيم، خصوصا في أوساط كبار السن، مما فرض عناية خاصة واستثنائية بهذه الشريحة من المواطنين الذين توقفت حياتهم في لحظة معينة على الخدمات العمومية التي يجب أن توفرها لهم حكومات دولهم.وهذا ما لم يتحقق بالكامل،وحيث ترك مئات الآلاف من هؤلاء يواجهون شراسة الفيروس القوية والفتاكة فرادى في غياب أي سند أو دعم من السلطات الصحية العمومية المختصة.والإشكال أن ترك هؤلاء يلقون مصيرهم لوحدهم لم يكن قرارا اختياريا وإراديا للسلطات المسؤولة، بقدر ما كان ظاهرة كارثية حتمية نتيجة عجز البنية الصحية عن استيعاب حاجيات طارئة بحجم لم تكن هذه السلطات تتوقعه.وبالتالي تجلت الحقيقة التي أعادت العديد منالإشكاليات المرتبطة بالمسألة الديموغرافية إلى واجهة الاهتمام .
فمن جهة، فقد تأكد أن الجهود الكبيرة والضخمة والمكلفة التي بذلتها حكومات العديد من الدول القوية والكبرى لتحقيق رعاية اجتماعية حقيقية للمواطنين المسنين لم تكن، لا نقول كافية لتحقيق تعميم الأمن الصحي، ولكن لم تندرج في سياق بنية صحية قوية ومتينة قادرة على مواجهة الأزمات الحقيقية الكبرى التي يظل حدوثها واردا في كل لحظة وحين .
كل هذا قد يبقى أقل أهمية من الإشكالية الأم التي زادت الجائحة من حجمها ومن خطورتها، ذلك أن هذه الفئة من المواطنين المسنين الذين تخلت الحكومات عن أعداد مهمة منهم في زمن الأزمة، والذين يواصلون الزيادة في قيمة التكلفة المالية لتمتعهم برعاية اجتماعية، وإن كانت نسبية، أعدادهم تتزايد و ترتفع بوتيرة سريعة، بما يعني أن هاجس التكفل بهؤلاء في الأزمنة العادية والطارئة سيزداد ويتنامى . فالإحصائيات المتاحة إلى حدود نهاية السنة الفارطة تكشف على أن نسبة مواطني دول القارة الأوربية الذين تتجاوز أعمارهم السبعين سنة سينتقل من 13,4 بالمائة حاليا إلى حوالي 21 بالمائة في أفق سنة 2045، وستصل في حدود سنة 2050 إلى 36 بالمائة، ويذهب بعض المتخصصين بعيدا في هذا الصدد بالقول إنه في أفق سنة 2050 فإن أعداد المواطنين الذين ستزيد اعمارهم عن 60 سنة ستكون أعلى من أعداد الأطفال،وإنه إلى حدود سنة 1950 كان عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في دول القارة العجوز لا يتجاوز نسبة 12 بالمائة من مجموع السكان.ومرد ذلك إلى العديد من العوامل، أهمها ارتفاع معدلات الأمل في العيش التي تجاوزت سقف 78 سنة في بعض الدول الأوروبية، وانخفاض معدلات الولادات بمستويات قياسية.
و إن بدت هذه الحقائق والمعطيات كعناوين بارزة لتطور العلوم الطبية وارتفاع مستويات العيش و الازدهار في تلك الدول، فإن في هذه النعمة، نقمة لا تقل وزنا و لا تأثيرا، لأن نعمة تحقيق الرفاهية للسكان تتحول في نفس الوقت إلى نقمة إحداث اختلالات بنيوية عميقة في الهرم الديموغرافي وفي التوازن الاجتماعي. لأن ارتفاع معدلات العيش وانخفاض نسب الولادات يعني الافتقاد التدريجي إلى التوازن بين الفئات العمرية داخل كل مجتمع ، مما يتسبب في تقلص أعداد الفئات النشيطة في العمر الانتاجي التي تدر عائدات على الدولة تمكنها من تغطية تكاليف التغطية و الحماية الاجتماعية للفئات العمرية من كبار السن، وهذا يعني عجزا متواصلا في التجاوب مع الطلب المتنامي وخصاصا ماليا متزايدا لتلبية حاجيات المواطنين المسنين. إننا بصدد الحديث في هذا السياق عما يمكن أن نسميه ب(شيخوخة المجتمعات).
وبعيدا عن القضايا والاشكاليات الكبرى والمستعصية التي تتسبب فيها هذه التحولات العميقة في التركيبة البشرية وخطورة تأثيراتها العميقة في دول كبرى تمثل القوى الاقتصادية العظمى والمهيمنة على الاقتصاد العالمي، مما يعطي الشرعية من اليوم للحديث عن خريطة النفوذ العالمي في المستقبل ارتباطا بهذه المتغيرات الديموغرافية، وعما إذا كانت هذه الدول ستفقد قوتها الاقتصادية والنفوذ المترتب عن تلك القوة بسبب خطر الفناء الديموغرافي الذي يهددها .
دعنا من هذه الهواجس الكبرى التي لا أحد يملك حتى مجرد مشاريع أجوبة أولية عن الأسئلة الحارقة التي تطرحها ، لنعود إلى ما ألقت به جائحة كورونا من انشغالات كبيرة ومقلقة تهم قدرة التطور العلمي والصحي الذي حققته العديد من الدول الأوروبية وغيرها في باقي مناطق المعمور، والذي تتغنى به شعوبها كعناوين بارزة لتحقيق أعلى معدلات الازدهار والرغد في العيش، على مسايرة حاجيات شرائح عريضة من سكانها، خصوصا في زمن الأزمات الطارئة ؟ مع استحضار الحقيقة التي أضحت ثابتة مفادها أن الأزمات الكبرى المحدقة بالعالم صارت بطبيعتها أزمات طارئة مرتبطة بالحقول العلمية البيولوجية والجرثومية والنووية وما شابهها، لأن لا أحد، بمن في ذلك العلماء والمتخصصون، بإمكانهم الجزم اليوم أو غدا، بأن الأبحاث والاشتغال في كل هذه الحقول العلمية الدقيقة، خالية من المخاطر والأخطاء وحتى من النيات السيئة لتجنيب العالم مثل الكابوس الكارثي الذي عاشه طيلة سنتين كاملتين، و لا يزال يتخوف مما قد يترتب عنه.
استفاقت دول القارة العجوز من الصدمة العنيفة التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية الطارئة المتمثلة في جائحة كورونا، على حقائق كثيرة مستخلصة من دروس السنتين العجاف التين عاشتهما الإنسانية، بسبب فيروس غير مرئي لا يزال جاثما على انشغالات المجتمع الدولي برمته، منبها إلى إمكانية عودته من جديد من خلال تواصل توالد سلالات كثيرة ومتعددة عجز العقل البشري عن فهم أسباب كل هذه القوة التي يتملكها الفيروس .
ومن المؤكد فإن الحقيقة الديموغرافية كانت من أهم الحقائق التي دفعت بها الأزمة الصحية العالمية إلى واجهة الاهتمام، حيث عجزت كبريات الدول التي تتغنى بقوة وصلابة بنيتها الصحية على الاستجابة إلى الحاجيات الملحة التي توقفت عليها حياة شريحة هامة من السكان، والمتمثلة في المواطنين المسنين.إذ من المعلوم أن فيروس كورونا وجد تربته الصالحة في الأشخاص الذين يعانون من هشاشة اجتماعية أو ضعف في المناعة، أو هما معا، وهذه أهم العوامل التي مكنت الفيروس من الانتشار كالنار في الهشيم، خصوصا في أوساط كبار السن، مما فرض عناية خاصة واستثنائية بهذه الشريحة من المواطنين الذين توقفت حياتهم في لحظة معينة على الخدمات العمومية التي يجب أن توفرها لهم حكومات دولهم.وهذا ما لم يتحقق بالكامل،وحيث ترك مئات الآلاف من هؤلاء يواجهون شراسة الفيروس القوية والفتاكة فرادى في غياب أي سند أو دعم من السلطات الصحية العمومية المختصة.والإشكال أن ترك هؤلاء يلقون مصيرهم لوحدهم لم يكن قرارا اختياريا وإراديا للسلطات المسؤولة، بقدر ما كان ظاهرة كارثية حتمية نتيجة عجز البنية الصحية عن استيعاب حاجيات طارئة بحجم لم تكن هذه السلطات تتوقعه.وبالتالي تجلت الحقيقة التي أعادت العديد منالإشكاليات المرتبطة بالمسألة الديموغرافية إلى واجهة الاهتمام .
فمن جهة، فقد تأكد أن الجهود الكبيرة والضخمة والمكلفة التي بذلتها حكومات العديد من الدول القوية والكبرى لتحقيق رعاية اجتماعية حقيقية للمواطنين المسنين لم تكن، لا نقول كافية لتحقيق تعميم الأمن الصحي، ولكن لم تندرج في سياق بنية صحية قوية ومتينة قادرة على مواجهة الأزمات الحقيقية الكبرى التي يظل حدوثها واردا في كل لحظة وحين .
كل هذا قد يبقى أقل أهمية من الإشكالية الأم التي زادت الجائحة من حجمها ومن خطورتها، ذلك أن هذه الفئة من المواطنين المسنين الذين تخلت الحكومات عن أعداد مهمة منهم في زمن الأزمة، والذين يواصلون الزيادة في قيمة التكلفة المالية لتمتعهم برعاية اجتماعية، وإن كانت نسبية، أعدادهم تتزايد و ترتفع بوتيرة سريعة، بما يعني أن هاجس التكفل بهؤلاء في الأزمنة العادية والطارئة سيزداد ويتنامى . فالإحصائيات المتاحة إلى حدود نهاية السنة الفارطة تكشف على أن نسبة مواطني دول القارة الأوربية الذين تتجاوز أعمارهم السبعين سنة سينتقل من 13,4 بالمائة حاليا إلى حوالي 21 بالمائة في أفق سنة 2045، وستصل في حدود سنة 2050 إلى 36 بالمائة، ويذهب بعض المتخصصين بعيدا في هذا الصدد بالقول إنه في أفق سنة 2050 فإن أعداد المواطنين الذين ستزيد اعمارهم عن 60 سنة ستكون أعلى من أعداد الأطفال،وإنه إلى حدود سنة 1950 كان عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في دول القارة العجوز لا يتجاوز نسبة 12 بالمائة من مجموع السكان.ومرد ذلك إلى العديد من العوامل، أهمها ارتفاع معدلات الأمل في العيش التي تجاوزت سقف 78 سنة في بعض الدول الأوروبية، وانخفاض معدلات الولادات بمستويات قياسية.
و إن بدت هذه الحقائق والمعطيات كعناوين بارزة لتطور العلوم الطبية وارتفاع مستويات العيش و الازدهار في تلك الدول، فإن في هذه النعمة، نقمة لا تقل وزنا و لا تأثيرا، لأن نعمة تحقيق الرفاهية للسكان تتحول في نفس الوقت إلى نقمة إحداث اختلالات بنيوية عميقة في الهرم الديموغرافي وفي التوازن الاجتماعي. لأن ارتفاع معدلات العيش وانخفاض نسب الولادات يعني الافتقاد التدريجي إلى التوازن بين الفئات العمرية داخل كل مجتمع ، مما يتسبب في تقلص أعداد الفئات النشيطة في العمر الانتاجي التي تدر عائدات على الدولة تمكنها من تغطية تكاليف التغطية و الحماية الاجتماعية للفئات العمرية من كبار السن، وهذا يعني عجزا متواصلا في التجاوب مع الطلب المتنامي وخصاصا ماليا متزايدا لتلبية حاجيات المواطنين المسنين. إننا بصدد الحديث في هذا السياق عما يمكن أن نسميه ب(شيخوخة المجتمعات).
وبعيدا عن القضايا والاشكاليات الكبرى والمستعصية التي تتسبب فيها هذه التحولات العميقة في التركيبة البشرية وخطورة تأثيراتها العميقة في دول كبرى تمثل القوى الاقتصادية العظمى والمهيمنة على الاقتصاد العالمي، مما يعطي الشرعية من اليوم للحديث عن خريطة النفوذ العالمي في المستقبل ارتباطا بهذه المتغيرات الديموغرافية، وعما إذا كانت هذه الدول ستفقد قوتها الاقتصادية والنفوذ المترتب عن تلك القوة بسبب خطر الفناء الديموغرافي الذي يهددها .
دعنا من هذه الهواجس الكبرى التي لا أحد يملك حتى مجرد مشاريع أجوبة أولية عن الأسئلة الحارقة التي تطرحها ، لنعود إلى ما ألقت به جائحة كورونا من انشغالات كبيرة ومقلقة تهم قدرة التطور العلمي والصحي الذي حققته العديد من الدول الأوروبية وغيرها في باقي مناطق المعمور، والذي تتغنى به شعوبها كعناوين بارزة لتحقيق أعلى معدلات الازدهار والرغد في العيش، على مسايرة حاجيات شرائح عريضة من سكانها، خصوصا في زمن الأزمات الطارئة ؟ مع استحضار الحقيقة التي أضحت ثابتة مفادها أن الأزمات الكبرى المحدقة بالعالم صارت بطبيعتها أزمات طارئة مرتبطة بالحقول العلمية البيولوجية والجرثومية والنووية وما شابهها، لأن لا أحد، بمن في ذلك العلماء والمتخصصون، بإمكانهم الجزم اليوم أو غدا، بأن الأبحاث والاشتغال في كل هذه الحقول العلمية الدقيقة، خالية من المخاطر والأخطاء وحتى من النيات السيئة لتجنيب العالم مثل الكابوس الكارثي الذي عاشه طيلة سنتين كاملتين، و لا يزال يتخوف مما قد يترتب عنه.
 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية