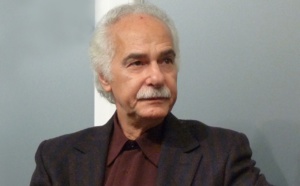العلم الإلكترونية - بقلم بدر بن علاش
ونحن على مقربة من الاستحقاقات الانتخابية،خرجت أخيرا مجموعة من استطلاعات الرأي بمؤشرات قد يراها البعض صادمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكر أن 60 في المائة من المستجوبين المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية المغربية، وأن أزيد من 70 في المائة لا يثقون أيضا في الحكومة، والأدهى من ذلك أن 90 في المائة لا يثقون أيضا في قدرة هذه الأخيرة على مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
لكن، وكما يقال "إذا عُرف السبب بطل العجب" فالجميع يعلم البون الكبير الذي يتسع يوما عن يوم بين فئة عريضة من المواطنين والساسة، والسياسة عموما، حيث انتقلنا من "بُعبع" السياسة التي طالما أخافت الكثيرين في سنوات وصفها البعض بـ "سنوات الرصاص"، إلى النفور منها، واعتبارها مجرد مجال للمصالح الضيقة والربح السريع، و"كُروش لحرام" و الريع وغيرها من الأوصاف القدحية.
ونحن على مقربة من الاستحقاقات الانتخابية،خرجت أخيرا مجموعة من استطلاعات الرأي بمؤشرات قد يراها البعض صادمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكر أن 60 في المائة من المستجوبين المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية المغربية، وأن أزيد من 70 في المائة لا يثقون أيضا في الحكومة، والأدهى من ذلك أن 90 في المائة لا يثقون أيضا في قدرة هذه الأخيرة على مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
لكن، وكما يقال "إذا عُرف السبب بطل العجب" فالجميع يعلم البون الكبير الذي يتسع يوما عن يوم بين فئة عريضة من المواطنين والساسة، والسياسة عموما، حيث انتقلنا من "بُعبع" السياسة التي طالما أخافت الكثيرين في سنوات وصفها البعض بـ "سنوات الرصاص"، إلى النفور منها، واعتبارها مجرد مجال للمصالح الضيقة والربح السريع، و"كُروش لحرام" و الريع وغيرها من الأوصاف القدحية.
وحتى نكون صادقين مع أنفسنا،وفي إطار معالجة نقدية صريحة،فإن الأرقام التي تخرج بها بعض الاستطلاعات، وإن شكك البعض في مدى احترامها للجوانب العلمية المؤطرة لها، تحمل جانبا من الصواب، وإن اختلف حجم المسؤولية فيها بين مختلف الفاعلين السياسيين، حتى أن المتتبع للشأن السياسي في بلادنا قد يشعر بالحيرة من أين سيبدأ؟ وأين سينتهي به تفكيره إذا ما أراد استحضار بعض الأمثلة الحية؟ بل قد يصاب بالاكتئاب وليس غياب الثقة، إذا ما وقف على بعض الممارسات التي لطخت صورة السياسة خلال العشرية الأخيرة.
ألم يقف المواطن على بعض الأحزاب التي تنكرت له، و أدارت ظهرها له في أول امتحان، وتملصت من الشعارات التي كانت ترفعها يمينا و شمالا بمجرد تسلمها مقود التدبير الحكومي، خلال هذه الولاية والتي سبقتها، وعوض وضعها لقطار التنمية على سكته الصحيحة، وإحقاق الحقوق والحريات والمكتسبات التي جاء بها دستور 2011، عادت بالمغرب إلى الوراء، ولم نعد نسمع من أفواه أبواقها و ذبابها سوى مصطلحات سياسية غريبة، و التباكي عند أي امتحان، وخطاب المظلومية في كل زلة أو قرار لا شعبي، بل محاولة تغليط الرأي العام أحيانا أخرى...
ألم تنشغل الأغلبية الحكومية داخل البرلمان بصراعات جانبية بين مكوناتها الحزبية، في مسرحية سيئة الإخراج، ومسلسل من المكائد، وحفر الحفر والدسائس "حملة المقاطعة مثلا"،وتبادل الاتهامات المجانية،واتخاذ القرارات والتراجع عنها بمجرد تعالي أصوات الرفض الشعبية،كما حصل مع مشروع قانون الموصوف بـ "تكميم الأفواه"،وبالتالي غاب الانسجام و الوضوح، ليبقى المواطن المغلوب على أمره تائها في غابة الوحوش في ظلمة حالكة.
ألم يتم تقزيم النقاش السياسي، ونحن على أبوب استحقاقات انتخابية، في أمور لا تهم المواطن في شيء من قبيل القاسم الانتخابي،واللوائح، وبالتالي تكريس صورة سلبية تجاه الأحزاب، واعتبارها مجرد "دكاكين" انتخابية لا تبحث سوى عن تقاسم "غنيمة" المقاعد البرلمانية، في حين يبقى هم المواطن المغلوب على أمره،ماذا سيكسب جيبه في خضم أزمة كورونا غير المسبوقة؟ وكيف السبيل لضمان خدمات اجتماعية ذات جدوى وتحترم كرامته؟ وهو ما عبر عنه أيضا مجموعة من المواطنين الذين تم استطلاعهم،عندما تبين أن 51 في المائة من المستجوبين يتطلعون إلى تحسين قطاع التعليم الذي اعتبره الكثيرون بـ "المشروع الفاشل"، وأبدى 31 في المائة رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و33.53 في المائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر. كما أن أكثر من نصف المغاربة (59 في المائة) لا يثقون في مؤسسة القضاء، لترتفع هذه النسبة لدى الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، لتصل إلى 60 في المائة، فيما صرح 82 في المائة أن الذين يملكون (وساطة) في المحاكم، هم من يحصلون على أحكام لصالحهم، وبالتالي فإن هذه الأرقام وغيرها تؤكد مجددا أن للمواطن أشياء أخرى تستحق الاهتمام.
ومهما قيل، فإن باب الأمل يجب أن يبقى دوما مفتوحا، أمل في غد أفضل يستعيد فيه المواطن ثقته الكاملة في الفاعلين السياسيين الجادين،أصحاب الصفحة البيضاء الخالية من أي شوائب، وتدفعه نحو مشاركة مكثفة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبلوغ التغيير المنشود.
ولعل أول ما ينبغي الانتباه إليه هنا هو ضرورة التعامل مع المغاربة عموما، في الزمان والفضاء المفتوحين،بشفافية و وضوح، بما يعيد إليه الثقة في مؤسساته المنتخبة. فكما قال الأديب العربي مصطفى صادق الرافعي "الذي يحيا بالثقة تُحييه الثقة" ،وإلا سيتم سكب الأكواب الواحد تلو الآخر فقط في الرمال الصحراوية الجافة.
ونظرا لما لعنصر "الثقة" من أهمية في الوقت الراهن، فقد كان بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأخير، ذكيا في معالجته لها، وهو يتحدث عن مسار التلقيح الذي بدأ في بلادنا، عندما أكد بالحرف"ضرورة تحلي الحكومة بالمسؤولية والالتزام، وعدم إطلاق وعود وأجندات زمنية تتعلق بإنهاء عملية التلقيح الجماعي في نهاية شهر مارس وقبل شهر رمضان. وهي الوعود التي سيكون من الصعب الوفاء بها لأسباب موضوعية تتعلق بمحدودية إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي أمام الارتفاع المهول للطلب"، وبالتالي فإن هذا البلاغ،وضع في حسبانه العديد من الوعود و الالتزامات التي تأخذها الحكومة في كثير من الحالات ولا تفي بها،بل وتضع لها أجندة زمنية محددة، لكن في الأخير تخلف الميعاد مع المواطن .
وبالتالي على المواطن، ورغم الصدمات و الفواجع المتتالية التي تلقاها،التمسك بخيط التغيير الذي آن الأوان لينتقل من نقاشات الصالونات و المقاهي وغيرها إلى فعل أكيد، فالذين يعزفون على أنغام المقاطعة ،بشكل مقصود أو غير مقصود، يخدمون فئة لا يهمها إلا فشل الحكومة بعدما تحولت علاقتهم إلى علاقة "الشيخ بالمريد"، وعلى من فقد ثقته ألا يضع كل الأحزاب في كفة واحدة. فالتاريخ يشهد بأن هناك أحزابا على قلتها وقفت إلى جانب المغاربة في أشد الصعاب إبان الاستعمار و بعد الاستعمار، والإسهام في بناء صرح الوطن،والدفاع عن المؤسسات والثوابت الوطنية، والترافع من أجل إحقاق الديمقراطية والحقوق و العدالة الاجتماعية، والعبرة هي أن "الأحزاب أحزاب"...
المناسبة شرط
الحادث المؤسف الذي عرفته مدينة طنجة،والذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء،يؤكد أننا بعيدين عن تفعيل مبدأ راسخ في الدستور على أرض الواقع، ألا وهو "ربط المسؤولية بالمحاسبة" وإلا ما معنى أن تصف لنا السلطات المحلية لولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة الوحدة صناعية ب "السرية" في وقت باتت أعين من لا تنام لهم الأعين تعلم ما بداخل الأنفاس وما تفكر فيه العقول.
إننا هنا أمام صورة أخرى للتهرب من المسؤولية،فهل قدرنا دوما أن نجلد الذات و القول لو كنا في بلد ديمقراطي ل....
 رئيسية
رئيسية 








 الرئيسية
الرئيسية